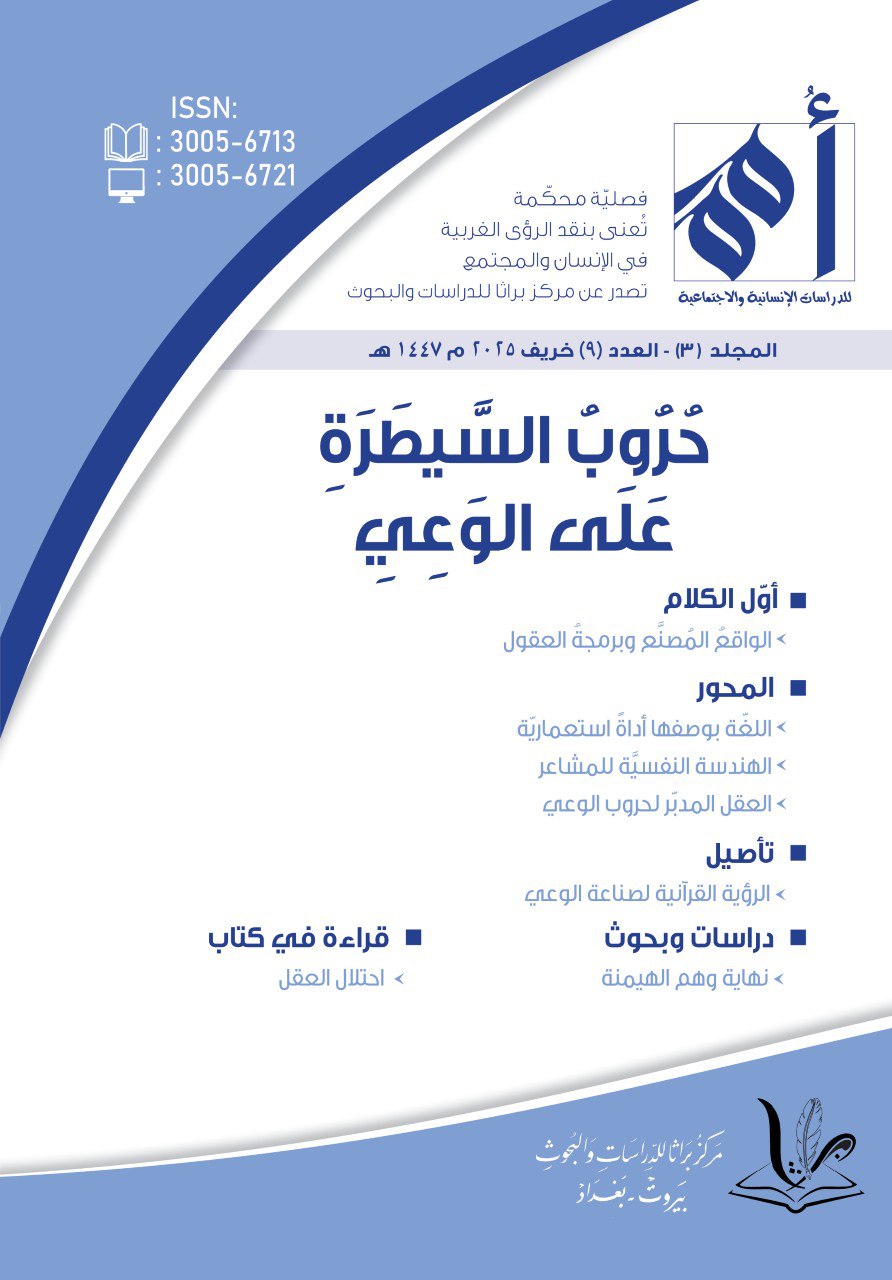
فنحن أمام حروب من نوعٍ جديد؛ حيث تُخاض بالمفاهيم، والصور، والمصطلحات، والسرديَّات. إنّها حروب السيطرة على الوعي؛ حيث يصبح تشكيل الرأي، وصناعة الواقع، وتوجيه القناعات، جزءًا من معركة أشد فتكًا من الحرب التقليديَّة؛ لأنّها تُمارَس من الداخل، في صمتٍ ونعومة، دون أن تترك وراءها دماء، بل تخلّف إنسانًا مُفرَّغًا، راضيًا بقهره، ومدافعًا عن سجّانه.
لقد تغيَّرت بنية السيطرة: فبدلًا من القمع، هناك الإقناع، وبدلًا من الوصاية الفجَّة، هناك صناعة الرغبة. لم تعد الهيمنة تفرض بالقوة، بل تُزرع في النفوس عبر الإعلام، والتعليم، والفنّ، والتقنيَّة، وحتى الدين حين يُفرَّغ من مضمونه ويُعاد تصنيعه. ووسط هذا المشهد، أضحت المعركة بين وعي مستنير، ووعي مبرمج، بين من يرى العالم بعينيه، ومن يُملى عليه كيف يراه.
وفي قلب هذه المعركة، تلعب النخب الثقافيَّة دورًا محوريًّا: فمن كان يُفترض بهم أن يقودوا الوعي، أصبح كثير منهم يُعيد إنتاج أدوات السيطرة بلغةٍ "عقلانيَّة"، أو خطابٍ "حداثي"، أو تحليلٍ "موضوعيّ" يخفي في طيّاته تسليمًا بالهزيمة، وتطبيعًا مع المستبدّ.
فمن خلال فرض لغة المُستعمِر كلغة رسميّة في الإدارة والتّعليم والقضاء، تمَّ إحداث قطع معرفي بين المجتمعات المُستعمَرة وتُراثها، حيثُ صار إتقان لغة المُستعمِر شرطًا للوصول إلى المراكز الاجتماعيّة والاقتصاديّة المرموقة. هذه السّياسة اللّغويّة لم تهدف فقط إلى تسهيل إدارة المُستعمرات، بل أيضًا إلى خلق نُخبة محلّيّة مُتحدّثة بلغة المُستعمِر، منفصلة عمّن يُطلق عليهم «الأهالي»، ممّا عمَّق الفجوات الطّبقيّة وأضعف التّماسك الاجتماعي في تلك البلاد.
وعلى النّقيض، لجأ الكثير من حركات التّحرّر الوطني إلى إحياء اللّغات المحلّيّة كفعل مقاومة، مثلما حدث في الجزائر مع تكثيف تعليم اللّغة العربيّة خلال الثّورة التّحريريّة، أو في الهند مع حركة «الهنديّة» لمقاومة الهيمنة الإنكليزيّة. وهكذا، أصبحت المعركة اللّغويّة جزءًا جوهريًا من معركة التّحرّر، حيثُ مثّلت اللّغة ساحة للصّراع بين إرادة البقاء الثّقافي وإرادة الهيمنة. وكما يقول المفكّر الجزائري مالك بن نبي: «الاستعمار لا يكتفي بسرقة الأرض، بل يسرق الوعي نفسه عبر اللّغة».
ليسَ فقط على مستوى نهجِ الأخبارِ أو الترفيهِ، بل من خلالِ إنتاجِ نموذجٍ حضاريٍّ متكاملٍ يخدمُ الهيمنةَ والاستعمارَ؛ إذ يقومُ على الفردانيّةِ، والاستهلاكِ، والفلسفةِ النيوليبراليّةِ. ينطلقُ البحثُ من تحليلِ الإعلامِ بوصفه قوّةً ناعمةً ترسِّخُ الهيمنة الثقافيّةَ، وتفتح المجالَ أمامَ أشكالٍ أخرى من السيطرةِ السياسيّةِ والاقتصاديّةِ.
يتناولُ البحثُ أدوارَ السينما والتلفزيونِ، باعتبارِهما أدواتٍ كلاسيكيّةً أسهمتْ في نشرِ الخيالِ الاستعماريِّ، وتعميمِ أنماطِ الحياةِ الغربيّةِ، ثمَّ يركِّزُ على الإعلامِ الرقميِّ بوصفِه مرحلةً جديدةً في هندسةِ الوعيِ الجماعيِّ؛ حيثُ تتحكَّمُ الخوارزميّاتُ في صياغةِ الرأيِ العامِّ، وتوجيهِ السلوكِ. ويناقشُ التبعاتِ والانعكاساتِ النفسيّةَ والاجتماعيّةَ لهذه الهيمنةِ، من تكريسِ النزعةِ الاستهلاكيّةِ إلى تآكلِ الهويّةِ الجماعيّةِ، وصعودِ "الإنسانِ ذي البُعدِ الواحدِ".
وفي المقابلِ، يطرحُ البحثُ استراتيجيّاتٍ للمقاومةِ والتحرّرِ الإعلاميِّ، عبرَ استعادةِ السرديّاتِ المحليّةِ، وبناءِ تحالفاتٍ ثقافيّةٍ بديلةٍ، مؤكِّداً أنَّ الإعلامَ لا يمكنُ أن يكونَ محايدًا، بل هو انعكاسٌ للبِنيةِ الفكريّةِ التي يحملُها.
ويهدف إلى تحليل البنى النظريَّة والنفسيَّة المرتبطة بالمشاعر، ما يوضّح الأسس والقواعد التي تُبنى عليها استراتيجيَّات تشكيل المشاعر في الإطار العام، خاصَّة أنَّ الهندسة النفسيَّة للمشاعر لا تقتصر على إثارة الانفعالات المؤقتة، بل تُسهم في إعادة تشكيل البنيَّة النفسيَّة للأفراد والمنظومات الاجتماعية بأكملها، كما يستعرض أدوات الإعلام في توجيه الانفعالات الجماعيَّة، وتوجيه الجماهير نحو ومواقف وسلوكيات معيَّنة.
كما يستعرض تأثيرات هذه العمليَّة على الفرد والمجتمع، من خلال حالات تطبيقيَّة في كيفيَّة توظيف وسائل الإعلام للخطاب العاطفيّ من العالم العربيّ، لا سيما في مناطق الصراعات والتوترات السياسيَّة، فيقدّم نماذج من الواقع العربي تبرز هذا التأثير بوضوح، لا سيما في المسارات السياسيَّة أو الأزمات. (لبنان، وفلسطين المحتلة)، ويخلص إلى ضرورة تعزيز الوعي النقديّ في الخطاب الإعلاميّ العاطفيّ، لحماية الصحة النفسيَّة والاجتماعية، تترك آثارًا طويلة المدى تتجاوز اللحظة الإعلاميَّة ذاتها، ما يستدعي ضرورة الوعي النقديّ بالمضامين الإعلاميَّة، ودراسة الخطاب العاطفيّ بوصفه أداة سلطويَّة لا تقلّ خطرًا عن الأدوات السياسيَّة والاقتصاديَّة.
وقد هدفت هذه الورقة البحثيّة إلى التمييز بين المعرفة المسلّطة والمعرفة الحرّة، وإلى تحليل العلاقة "التكامليّة" بين هذه المؤسّسات، لصياغة "الحقيقة الرسميّة" وتكريسها واقعًا لا جدال فيه، من خلال استخدام لغة العلم، والأرقام، وبمساعدة استراتيجيّات الإقناع وأدواته.
ومن هنا، أصبح من الصعب الحديث عن حياد وسائل الإعلام وموضوعيّتها، وهي التي بيدها تحديد ما يجب أن يُنشر، وما يجب أن يُهمل، بل كيف يجب أن يُنشر وفق آليّات الحذف، والتضخيم، والتهميش، والانتقاء في سياق تحقيق أكبر قدرٍ من غزو العقول والأفكار. فاقتضت مصالح الحكومات السيطرة على النخب الإعلاميّة، وخلق التناسق التامّ بين ما يسعون إليه من أهداف، وما تقدّمه الوسائل الإعلاميّة من مخرجات، حتّى ولو من خلال اللجوء إلى تزييف الحقائق. ففي العدوان على غزَّة، برزت بوضوح "الحقيقة الرسميّة" المزيّفة من خلال تعاونٍ وثيقٍ بين الحكوماتٍ والنخب الإعلاميّة الغربيّة والعربيّة، ومراكز الأبحاث المرتبطة بالمصالح المرتبطة بالدول المهيمنة.
وفي الختام، سعت هذه الوريقات إلى تقديم نموذجٍ عمليّ، وما أكثر النماذج في هذا السياق ليس فقط على المستوى السياسيّ، بل الاقتصاديّ والثقافيّ والاجتماعيّ.
يوضّح البحث أنَّ هذه المراكز تعمل ضمن شبكة معقّدة، تتقاطع فيها السياسة والاقتصاد والإعلام والتمويل، ما يمنحها قدرة فاعلة على إعادة تعريف المشكلات، وصياغة الحلول، بما يخدم مصالح القوى المُهيمنة. كما يركّز على كيفيَّة توظيفها لمفاهيم، مثل "الدولة الفاشلة" و"الإسلام المعتدل"، في سياقات إقليميَّة حسَّاسة، كالعراق، ولبنان، وسوريا، وإيران، الأمر الذي يجعلها شريكًا في إنتاج الشرعيَّة للسياسات التدخليَّة. ويستعرض البحث نماذج لمؤسَّسات بارزة كـ (RAND) و(Brookings) و(WINEP)، كاشفًا طبيعة انحيازها البِنيويّ، ودورها في تدوير النخب، والتأثير في الخطاب الإعلاميّ. ويستند إلى قراءات نقديَّة غربيَّة داخليَّة (تشومسكي، فوكو)، لإبراز أبعاد التواطؤ المعرفيّ لهذه المراكز مع السلطة. ويخلص البحث إلى ضرورة بناء بدائل معرفيَّة محليَّة قادرة على مقاومة الاستعمار المعرفيّ الناعم، وصياغة سرديَّات تعكس أولويَّات المجتمعات واستقلاليَّتها.
ثم تبيّن العلاقة بين العقل بوصفه أداةً للتحليل والتدبّر، وبين الوحي بصفته أساسًا للهداية ومنبعًا للمعرفة الهادية، وهل هناك مواطن يختلفان فيما بينهما، أو يتقاطعان؟ أو أنّهما في انسجام وتكامل معرفيّ، يضمن فيهما الثاني استقامة الأول.
محاولة بيان الأثر المحوريّ للدولة الإيمانيَّة، بوصفها منظومة حضاريَّة تعمل بمبدأ العدل، وحقوق الإنسان، ثمّ تبيّن كيف يكون الحكم الرشيد، في تلك الدولة، ضامنًا أساسًا في صيانة الوعي وحفظه من أساليب الخداع والتزييف، التي تعمل على صناعتها أنظمة السيطرة الغربيَّة المعاصرة.
لتقدّم بعد ذلك مقارنة نقديَّة بين الرؤية القرآنيَّة لتشكّل الوعي وحفظه، وبين المنهجيّات المعاصرة، التي غالبًا ما تقدّم تقنيّات التضليل، والدعايات الإعلاميَّة لصناعة وعي مزيّف.
كشفت حدود القوَّة الأمريكيَّة وتناقضاتها البنيويَّة. ينطلق التحليل من فرضيَّة، مُفادها أنَّ هذه الهيمنة لم تُبنَ على تفوق خُلُقيّ أو حضاريّ، بل تأسَّست على مكر استراتيجيّ واستثمار لحظات الإنهاك الدَّوليّ، كما في الحرب العالميَّة الثانية. يعتمد المقال على أدوات التحليل النقديّ الرمزيّ، مستندًا إلى أعمال (فوكو)، و(إدوارد سعيد)، و(بودريار)، و(غرامشي)، لفهم دور الإعلام، والنخب، والنظام المعرفيّ العالميّ في إنتاج وَهْمِ الهيمنة وترويجه. كما يستعرض إخفاقات بنيويَّة كبرى في فيتنام، وأفغانستان، وأزمات العقوبات والتحالفات. ويختتم بدعوة إلى تحرّر الوعي الاستراتيجيّ، وتأسيس مشروع معرفيّ وسياديّ بديل، يتجاوز التبعيَّة، ويؤسِّس لعلاقات دَوليَّة أكثر ندِّيَّة وتوازنًا.
يناقش مفهوم "احتلال العقل" باعتباره أداةً رئيسةً في التأثير على الأفراد؛ حيث يجري التلاعب بالمعلومات، لإقناع الناس بآراء وأيديولوجيّات معيّنة عبر وسائل إعلام متنوّعة. يشير الكتاب إلى كيفيَّة تأثير الحرب النفسيَّة في الحروب المعاصرة، وكيف يمكن أن تساهم وسائل الإعلام في تغيير مواقف الرأي العام من خلال التلاعب المعلوماتي. يُفصّل الكتاب في استخدام "الإقناع القسريّ" عبر الأنظمة الحاكمة، التي تعتمد على الإعلام لتوجيه سلوك الشعب، كما يعرض طرقًا عمليَّة لتضليل الحقائق عبر أساليب متنوّعة. ويتطرّق الكتاب -أيضًا- إلى دور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ في نشر هذه الأفكار والآراء، وأثرها الكبير في التأثير على قناعات الأفراد. مضافًا إلى ذلك، يناقش الكتاب تقنيّات "غسل الدماغ"، وتأثير الإعلام العسكري، واستخدام مصطلحات عسكريَّة لتبرير الحرب، وتحقيق أهداف سياسيَّة. وفي النهاية، يدعو الكتاب إلى أهمّيَّة الوعي الإعلاميّ، لكشف التلاعب الذي يؤدّي إلى تغييرات في الفكر الجماعيّ.
التعليقات