فمن خلال فرض لغة المُستعمِر كلغة رسميّة في الإدارة والتّعليم والقضاء، تمَّ إحداث قطع معرفي بين المجتمعات المُستعمَرة وتُراثها، حيثُ صار إتقان لغة المُستعمِر شرطًا للوصول إلى المراكز الاجتماعيّة والاقتصاديّة المرموقة. هذه السّياسة اللّغويّة لم تهدف فقط إلى تسهيل إدارة المُستعمرات، بل أيضًا إلى خلق نُخبة محلّيّة مُتحدّثة بلغة المُستعمِر، منفصلة عمّن يُطلق عليهم «الأهالي»، ممّا عمَّق الفجوات الطّبقيّة وأضعف التّماسك الاجتماعي في تلك البلاد.
وعلى النّقيض، لجأ الكثير من حركات التّحرّر الوطني إلى إحياء اللّغات المحلّيّة كفعل مقاومة، مثلما حدث في الجزائر مع تكثيف تعليم اللّغة العربيّة خلال الثّورة التّحريريّة، أو في الهند مع حركة «الهنديّة» لمقاومة الهيمنة الإنكليزيّة. وهكذا، أصبحت المعركة اللّغويّة جزءًا جوهريًا من معركة التّحرّر، حيثُ مثّلت اللّغة ساحة للصّراع بين إرادة البقاء الثّقافي وإرادة الهيمنة. وكما يقول المفكّر الجزائري مالك بن نبي: «الاستعمار لا يكتفي بسرقة الأرض، بل يسرق الوعي نفسه عبر اللّغة».




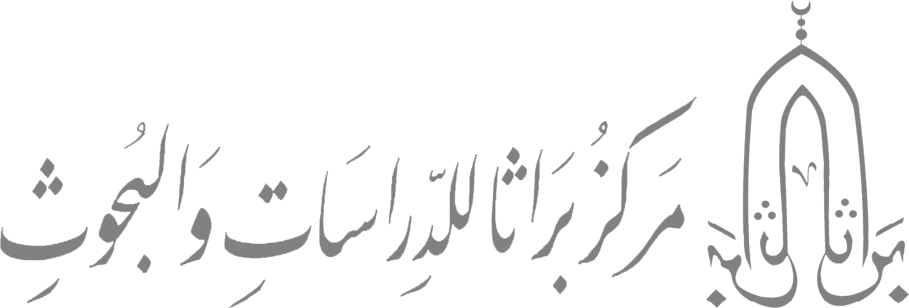
التعليقات