لا شك أنَّ هذا التحوُّل لم يأت من فراغ، وهو بطبيعة الحال لا يذهب إلى فراغ، مثله مثل أي ظاهرة اجتماعية عملت الحضارة الغربية على إنتاجها، أو إعادة تدوير إنتاجها، عمَّا كان موجوداً بشكل محدود في عصور سالفة.
و إزاء هذا الواقع، نحن معنيون بدراسة هذه الظاهرة على مستويين: الأول: دراسة الظاهرة نفسها لناحية طبيعة الأُسس التي قامت عليها، وطبيعة المُخرجات التي تذهب إليه؛ والثاني: دراسة العوامل الأساسية التي بسببها تنشأ الظاهرة الاجتماعية في ميادين الحضارة الغربية.
فلو أخذنا المشهدَ النسوي قبل الحرب العالمية الأولى، كمثالٍ على ذلك، ولو افترضنا أنَّ تلك الحرب لن تكتسحَ الكيانَ الأوروبي، وبالتالي لن يسودَ الجوعَ، ولن تقتل الملايين، لا سيما من الرجال، ولن تتعرض الحياة في مجال الأمن الاجتماعي إلى التشرّد والقلق على المصير، وهكذا بقية ما أفرزته هذه الحرب، فهل سيكون لدينا استفحال في ظاهرة ترك المرأة لبيتها وأسرتها والتحوُّل إلى يد عاملة في المصانع الحربية، والخادمة للوضع اللوجستي للحرب؟ بعد أن فقدت المُعيلَ، أباً أو زوجاً أو أخاً، نتيجة لما أكلته الحرب من الرجال؟
ولو أنَّنا تركنا لخيالنا أن يتمادى أكثر، وينظر حال المرأة التي دُعيت إلى تلبية أغراض الحرب في أوروبا، وهي تتلقى دعوة مُتشددة أكثر حينما بدأ الخزين الرجالي الأوروبي يتآكل في الحرب العالمية الثانية، ومن ثمَّ ليزدادَ العبءُ اللوجستيُّ على النساء بشكلٍ خطيرٍ للغاية؛ بحيث ترك آثاراً هائلة على المجتمعات الأوروبية بشكل عام، ومع هذه الآثار، كانت مظاهر تفكك الأسرة وتجارة الدعارة والعنف ضد المرأة وقضية المساواة وأمثالها تسيرُ بوتيرةٍ مُتصاعدةٍ جداً.
مع هذه النتائج التي لم يكن عالم الأفكار والفلسفات والإيديولوجيات هو المسؤول المباشر عنها، وإنَّما نشأت نتيجة لإفرازات الواقع الذي صنعته أغراض ساسة الحروب ومصانعها، ولكننا سنلاحظ أنَّ عوالمَ التنظير الفلسفي والفكري سرعان ما تلقفتها؛ لنجدَ سيمون دي بوفوار (1908ــ1968) تطرحُ ما سيُعرف فيما بعد بالأفكار المُتعلقة بما يُعرف بالنسوية (Feminism) ومنها راحت تتابع الظاهرة وهي تتلاقح مع أفكار أخرى؛ والتي جاءت هي الأخرى كتداعيات لظواهر متعددة، حتى بلغنا عالم السيداو (CEDAW) وما جرَّ من بعده من عوالم الاندفاع الغربي المعاصر نحو الشذوذ الجنسي.
ولستُ هنا في صدد الحكم القيمي والمعياري على كُلِّ هذه المظاهر، وإنَّما نسعى إلى الوصول إلى فهم التداخل بين نشأة الظواهر الاجتماعية ومُسبباتها، والغايات الكامنة وراء الترويج لظاهرة بعينها وقمع ما سواها؛ والآثار التي خلَّفتها على عوالم الإيديولوجيا والفلسفة، ومن ثمَّ دور الأخيرة في كلّ ذلك، بغية رؤية اللاعب الأساس الذي يقفُ خلفَ الستار.
لقد سعى الكثيرون إلى تصوير الأمور وكأنَّ كُلَّ ذلك إنَّما ينشأ من دوافع فكرية وفلسفية؛ ولكنَّ الواقعَ المعاصرَ أرانا الدور الكبير الذي تقوم به البروباغاندا في صناعة القطيع المؤدلج، والذي يمكن له أن يتجه إلى إنتاج الظاهرة الاجتماعية حتى لو كانت هذه الظاهرة مُخالفة للنمط العقدي المهيمن على المجموعة المستهدفة ذاتها، ما يحدو بنا إلى ألَّا نأخذَ الأمرَ من خلال الصورة الأولى بظاهرها، بل لا بُدَّ من الغوص أكثر لقراءة المشهد الحقيقي الذي يتخفَّى وراء ما أرادت الضجة الإعلامية أن تُخفيه. وقد أرتنا التجربةُ أنَّ هذا المشهد المستور يُخفي وراءه مشاهد متعددة هدفها إبقاء اللاعب الرئيس مستوراً ومخفياً، لأغراض تتعلق بتمرير الفكرة نفسها والتي يتمُّ تهويلها وتمريرها عبر الإعلام، فأصول لعبة التلاعب بالعقول (Mind manipulation) وشروط نجاحها هي إبقاء المتلاعبين في الخفاء، وعدم كشف هويتهم.




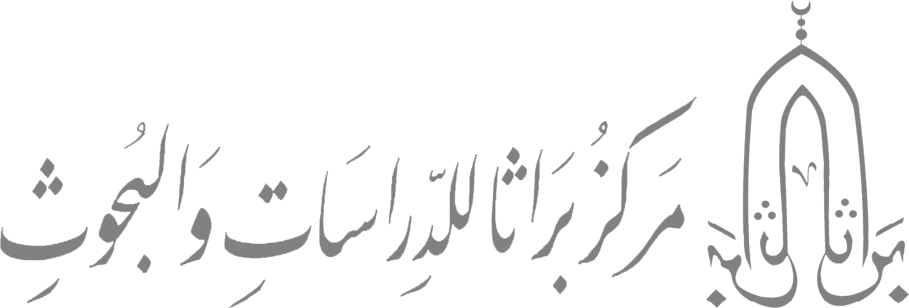
التعليقات